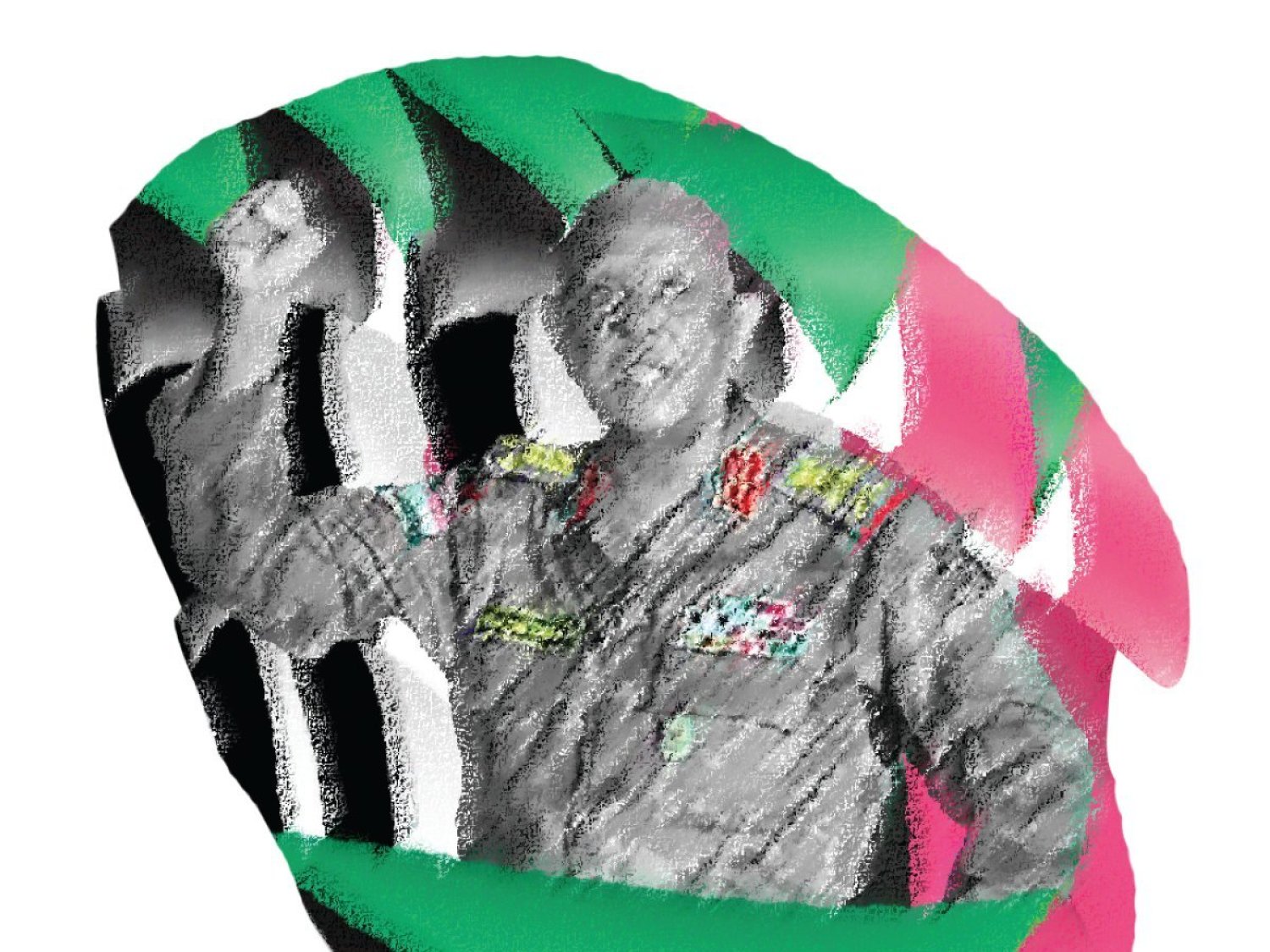تُبذَل يومي الاثنين (بعد غد) والثلاثاء المقبلين، محاولة جديدة لحل الأزمة الليبية من خلال مؤتمر يعقد في مدينة بالرمو، عاصمة إقليم صقلية الإيطالي، الذي هو إقليم سيئ السمعة بالنسبة لأجيال عاصرت الاحتلال الإيطالي لليبيا في النصف الأول من القرن الماضي.
وعلى الرغم من كثرة الأمراض التي يعاني منها الجسد الليبي، منذ 2011 حتى اليوم، ما بين فوضى واحتراب أهلي وانتشار للميليشيات المدجّجة بالأسلحة الثقيلة، تبدو إيطاليا متحمّسة لانعقاد المؤتمر وإنجاحه، وذلك، بعدما شعرت لبعض الوقت أن الفرنسيين يريدون الهيمنة على الملف الليبي.
يُعَد مؤتمر بالرمو حول ليبيا الأول من نوعه، بعد محاولة الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون، جمع الأفرقاء الليبيين في باريس الصيف الماضي. وبين مخاوف المقاطعين، وطموحات المشاركين في المؤتمر المزمع عقده في عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية، تمكن القادة الإيطاليون، على ما يبدو، من إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بقدرتهم على إدارة الملف الليبي أكثر من أي طرف أوروبي آخر.
ووفقاً للقاءات بين مسؤولين نفطيين من ليبيا وإيطاليا، جرت في مطلع هذا الشهر في لندن، بعيداً عن الأضواء، ازدادت أهمية ليبيا أخيراً. أما السبب فهو ما كُشف عنه من وثائق تتعلّق بمخزونها النفطي، وتحديداً، إمكانية القفز بالإنتاج من 1.6 مليون برميل يومياً إلى 3 ملايين برميل يومياً، في المستقبل المنظور، وهو ما يساعد في التغلب على النقص في سوق النفط العالمية، بعد إعادة ترمب فرض العقوبات على الصادرات الإيرانية.
في هذه الأثناء، واجهت إيطاليا ودول أوروبية أخرى مشكلات قانونية تخص التعاقدات مع حكومة المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فايز السراج، لأنها لم تحصل على مصادقة البرلمان، سواء فيما يتصل بتعاقدات النفط أو التعاقدات العسكرية والأمنية بشأن التصدي لوقف الهجرة غير الشرعية. ومعلوم أن زيادة إنتاج ليبيا من النفط يتطلب نوعاً من الاستقرار الأمني، وبُنية تشريعية وتنفيذية قادرة على حماية أي تعاقدات ترتبط بها الدولة مع الأطراف الخارجية.
- تسلم دعوات المؤتمر
مسؤولون وسياسيون ونشطاء ورموز قبلية من ليبيا ودول أخرى معنية، تلقوا أخيراً الدعوات لحضور مؤتمر بالرمو. وانقسم هؤلاء بين ثلاث فئات: الفئة الأولى وافق أفرادها على الحضور، وأفراد الثانية أعلنوا رفضهم المشاركة في المؤتمر من الأساس، أما أفراد الفئة الثالثة فوضعوا الدعوة جانباً، وباشروا إجراء الاتصالات والمشاورات قبل تحديد مواقفهم.
لقد وجهت إيطاليا دعوات لحضور مؤتمر بالرمو إلى «حكّام» طرابلس، وعلى رأسهم السراج وعدد من قيادات العاصمة، بمن فيهم أعضاء في «مجلس الدولة» الذي يعد امتداداً للبرلمان السابق الذي أسقط الليبيون معظم أعضائه من الإسلاميين في عام 2014. كذلك دُعيَت القيادات العسكرية والنيابية في شرق ليبيا، وزعماء في الجنوب أيضاً، وهو منطقة تعد ميداناً للتنافس التاريخي بين الإيطاليين والفرنسيين، وتوجد فيها مكوّنات ثقافية لها امتدادات قبلية في دول الجوار، مثل تشاد والنيجر وغيرهما.
أما على الصعيد الإقليمي، فمن المتوقع أن يكون هناك حضور لعدد من دول الجوار الليبي، منها مصر، وبلدان عربية شارك بعضها في مؤازرة زعماء التيارات الإسلامية ممن قادوا الانتفاضة المسلحة ضد حكم معمر القذافي عام 2011، بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي «ناتو».
وثمة اعتقاد على المستوى الدولي بأن ترمب يقف مع المحاولات الإيطالية لإنجاح الحل في ليبيا. إلا أن عدداً لا بأس به من الأطراف الأوروبية، في مقدمها فرنسا وألمانيا، غير متحمسين - كما يبدو - للدور الذي تريد إيطاليا أن تلعبه، منفردة، في هذا البلد الذي يحوي أكبر مخزون من النفط بين بلدان القارة الأفريقية.
أما بالنسبة للروس المعروفين ببحثهم الدؤوب عن أسواق لبيع السلاح، وعن مراسٍ دافئة على البحر المتوسط لحاملاتهم العسكرية، فما زالوا «يرتبّون» أمر المشاركة في مؤتمر بالرمو. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن لدى الروس علاقة قوية مع «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وأن حفتر زار موسكو أخيراً. ويقول مسؤول عسكري ليبي، إن الجنرال الذي حقق انتصارات لافتة على الجماعات المسلحة في مدينتي بنغازي ودرنة في الآونة الأخيرة، يشعر أن هناك «مؤامرة» يحيكها ضده الإيطاليون وقادة في «المجلس الرئاسي» وزعماء لجماعات إسلامية في الغرب الليبي.
- مشاورات... وذكريات
منذ الإعلان عن المؤتمر، انعقدت طوال الأيام الماضية مناقشات ساخنة في غرف للمشاورات بين أطراف ليبية في داخل البلاد، وفي فنادق وفيلات وشقق داخل مدن في دول بمنطقة الشرق الأوسط. ومن بيته على نيل العاصمة المصرية القاهرة، يقول أحمد قذّاف الدم، المسؤول السياسي في «جبهة النضال الوطني»، إن «الأطراف الليبية الفاعلة» جرى تغييبها عن هذا المؤتمر.
ويضيف الرجل، الذي كان يوماً من أكثر الشخصيات المقرّبة من العقيد القذافي، قائلاً إن «الغرب قوى استعمارية، ولا يريد أن يرى قوى وطنية ترفض محاولات هيمنته على ليبيا... القوى الوطنية الليبية هي التي تملك النفوذ على الأرض وتملك ثقة الناس، وغيابها يعني أن المؤتمر انتهى منذ بدايته، من حيث المكان والعنوان».
أيضاً في منتديات العاصمة المصرية، واصل الدكتور محمد زبيدة، القيادي في مؤتمر القبائل الليبية، مشاوراته بشأن حضور مؤتمر بالرمو أو التغيب عنه، بعدما تلقى دعوة للمشاركة فيه. وهو يقول معلقاً إن المؤتمر «ربما سيتضمن نتائج سلبية على مصر، ومحاولاتها التي تقوم بها منذ أكثر من سنة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية». ثم يستطرد موضحاً: «توجد رسالة موجّهة من أحد قيادات المجلس الرئاسي إلى مؤتمر بالرمو، يطلب فيها أن يكون من ضمن مُخرَجات المؤتمر، سحب مهمة توحيد المؤسسة العسكرية من مصر لصالح الأمم المتحدة، بحيث تشرف الأمم المتحدة بنفسها على ذلك».
وفي مدينة الإسكندرية المصرية، حيث تكثر زيارات القادة الليبيين إلى هذه المدينة، كما كانت عليه الحال في التاريخ القديم، انعقدت مناقشات واسعة بين نواب ونشطاء وإعلاميين، بشأن إيجابيات المشاركة في مؤتمر بالرمو وسلبياتها. ويقول عيسى عبد المجيد، رئيس الكونغرس التباوي (من أقلية التبو) الليبي، أثناء وجوده في المدينة إنه لن يشارك في بالرمو... لأن «هذا المؤتمر ولد ميتاً». والحقيقة، أن بعض المشاركين في المناقشات من هذا النوع استحضروا التاريخ الاستعماري الإيطالي لليبيا، وتطرّق عدة نواب ونشطاء وعسكريين أيضاً، إلى ما سموه «النوايا غير الطيبة لروما». وحسب عبد المجيد، فإن إقليم صقلية، الذي سيستضيف المؤتمر «يرتبط بذكريات مريرة لدى الليبيين... إذ تعرض كثيرون من الليبيين في زمن الاحتلال الإيطالي لليبيا، إلى النفي إلى صقلية، ولم يعرف مصيرهم أبداً. هذا أمر رمزي خطير جداً. هذه رمزية تهدف لإذلال الليبيين».
- موقف مصر
تدعم مصر منذ سنوات المشير حفتر، ومعها في ذلك، بدرجات متفاوتة، دول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة، وبلدان أوروبية على رأسها فرنسا، بالإضافة إلى التعاون الروسي في مجال المعلومات الاستخباراتية والأمنية. ويسيطر حفتر راهناً على المنطقة الشرقية من ليبيا المحاذية للحدود مع مصر. وكانت قد نشطت في هذه المنطقة، طوال أكثر من خمس سنوات، جماعات متطرفة مصرية وغير مصرية كانت تستهدف نظام الحكم في القاهرة، واتهمتها السلطات المصرية بتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها المئات من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.
ولهذا، كما يقول الدكتور زبيدة - الذي شارك في السابق في اجتماعات لليبيين في القاهرة - «تقف مصر ضد محاولات الزج بجماعات الإسلام السياسي والميليشيات ضمن المنظومة العسكرية». ويضيف: «الموقف المصري يتعارض مع مصالح الميليشيات المتحكمة في طرابلس، والمتحكمة بالتالي في المجلس الرئاسي. أما المجلس الرئاسي فلا يستطيع فعل أي شيء من شأنه إغضاب الميليشيات والجماعات المسلحة الموجودة في العاصمة. ولذا يحاولون إبعاد مصر عن هذا الدور، وإيكال هذا الأمر إلى الأمم المتحدة، وبالتالي، إدماج كل قادة الميليشيات بما فيها جماعات الإسلام السياسي، ضمن المؤسسة العسكرية».
ومن جانبه، يرى قذّاف الدم أن الإيطاليين «اختاروا بعض الأسماء المحسوبة عليهم». ويتابع: «تريد (إيطاليا) أن تفرض بعض العملاء الليبيين في الواقع الجديد، كبديل لحكومة السراج التي انتهى عمرها الافتراضي، وبالتالي، فهم يريدون إدارة الفوضى في ليبيا وليس إنهاءها». ثم أردف قائلاً إن الدول الغربية، وعلى رأسها إيطاليا، «تريد، ممن ستجلبهم لحكم ليبيا، أن يوقّعوا لها عقوداً جديدة... الدول الغربية لا تنظر إلى ليبيا إلا كحقل نفط أو حقل غاز. ومثل هذه البروباغاندا بشأن مؤتمر بالرمو، للأسف، لن تصنع حواراً جاداً ولا نظاماً شرعياً».
- أنصار النظام السابق
ورداً على سؤال عما إذا كان أي من أنصار النظام السابق ممن يعوّل عليهم، سيشارك في مؤتمر بالريمو، قال قذّاف الدم «الاختيارات لم تكن من الليبيين، أو من الأحزاب، أو من التنظيمات الموجودة على الساحة السياسية، سواءً من المعارضة أو من القوى الحية الليبية. هم (منظمو المؤتمر) اختاروا أسماء هكذا، كغطاء ونوع من تغليف الحقائق، وتمرير لمسرحية بأن كل الليبيين موجودون. للأسف سيؤدي الليبيون الحاضرون في المؤتمر دور الكومبارس. ولن ينجح (المؤتمر)... أنا لست متفائلاً بما يحدث».
ثم أردف أن «الغرب ليس جاداً في حل المشكلة الليبية، بل ما يريده هو إدارة الصراع، والحصول على امتيازات لبعض الدول، تمهيداً لوضع ليبيا تحت الوصاية، وهذا أمر سيردّ عليه الشعب الليبي».
وكرّرنا السؤال... هل هناك أطراف من النظام السابق ستشارك في مؤتمر بالرمو؟ فأجاب قذّاف الدم بشكل قاطع: «طبعاً... طبعاً... رغم عدم قناعتهم بمثل هذه المؤتمرات، فإنهم لا يريدون أن يعطوا حجة للعالم بأنهم ضد السلام أو الحوار... لكنهم، كقيادات متمرسة في العمل السياسي، يرون أن هذه الخطوات عبارة عن ذر للرماد في العيون أمام الليبيين، وتغيير بعض الوجوه التي لم يعد لها أهمية في الوجود في المشهد، بعدما تورطت بالسرقة والنهب أمام الليبيين».
- «لجنة حكماء طرابلس»
على صعيد آخر، في طرابلس، لعبت لجنة تسمى «لجنة حكماء طرابلس» دوراً غير مباشر، على الأقل، في إقناع أطراف متصارعة على نبذ الخلافات استعداداً لمؤتمر بالرمو. ويقول أحد من وجهت لهم الدعوة للحضور: «ما قامت له لجنة الحكماء في العاصمة كان مؤشراً على محاولة لسحب البساط من تحت أقدام كل الأصوات التي تنتقد المجلس الرئاسي، أو تنتقد وجود ميليشيات في طرابلس... إن مشاركة هؤلاء الخصوم في بالرمو سيعطي انطباعاً للعالم بأن التوافق قد تم، وأن المؤسسة العسكرية (بقيادة حفتر) ليس لها من سبيل إلا الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، وتولي السلطة المدنية للقيادة العسكرية».
ويعتقد أنصار نظام القذافي، من جهتهم، أن جماعة «الإخوان» و«الجماعة الليبية المقاتلة» (بعض قادة هذه الجماعات مدعوة لمؤتمر بالرمو) أقلية في الشارع الليبي. ويرون أن «الغرب يريد أن يفرض المجموعات التي أتى بها في 2011 تحت صواريخ (الناتو)، رغم أن الصواريخ لا تصنع شرعية لأحد». ويذهب أحد قادة النظام السابق إلى حد القول: «القبائل الليبية والجيش الليبي الحقيقي لن يسمحوا بعودة الاستعمار إلى ليبيا».
- شكوك بشأن «الإسلاميين»
وعودة إلى القاهرة، حيث يبدو في أروقة الدولة المصرية أن مصر ستشارك في المؤتمر، رغم كل المخاوف من الانحياز إلى خصومها من التيارات الإسلامية التي تعادي النظام المصري. وحتى ساعات قليلة مضت، كانت المشاورات داخل البيت المصري تدور حول مستوى المشاركة. وترى مصر أن وجودها، بأي مستوى، في مؤتمر بالرمو، بشكل عام، فيه قدر من الرغبة في الانخراط الإيجابي. وأن أي وفد مصري سيحضر إلى بالرمو «ستكون مشاركته إيجابية».
وللعلم، لم تتوقف الاتصالات بين الجانبين المصري والإيطالي حول الإعداد للمؤتمر والمخرجات المتوقعة منه. ولدى مصر محدّدات بعينها تخص القضية الليبية، من بينها «الحفاظ على وحدة التراب الليبي» و«السيادة الليبية على أراضيها» و«الحفاظ على مؤسسات الدولة للاضطلاع بدورها»، و«توحيد المؤسسة العسكرية الليبية». لكن القاهرة تؤكد على ضرورة أن تأتي «التسوية عبر حوار ليبي - ليبي، وليس من الخارج».
الدكتور زبيدة، القيادي في مؤتمر القبائل الليبية، يرى أن جماعات الإسلام السياسي تقف مع إيطاليا وراء مؤتمر بالرمو. ويقول إن قادة من «الإخوان» و«الجماعة الليبية المقاتلة»، بدعم من دول إقليمية أيضاً، عقدوا اجتماعاً في العاصمة الليبية، للوقوف ضد تحركات «الجيش الوطني» الذي يقوده حفتر، ويحظى بتأييد مصري، في الجنوب الليبي. ويضيف أن زعماء في «المجلس الرئاسي» يتعاونون في هذا المجال من أجل «قطع الطريق على الجيش الوطني الليبي في الجنوب، وذلك بأن يقوم المجلس الرئاسي بإرسال قوة للجنوب لبسط الأمن هناك قبل أن يتحرّك الجيش الوطني إليها».
وفي هذا الاتجاه يقول عيسى عبد المجيد، الذي يتركز وجود قبيلته (التبو) في الجنوب الليبي، أن لدى إيطاليا برامج، بالاتفاق مع بعض الأطراف، من أجل إعادة الإسلاميين إلى السلطة، كما كانت عليه الحال في 2012 و2013. ويضيف عبد المجيد: «لدى إيطاليا النية للتوغل في الجنوب الليبي، لكن من المستحيل أن ندع إيطاليا تتدخل في هذه المناطق... وإذا حاولت فعل ذلك، فستخسر ما لديها من مصالح في الوقت الراهن إلى الأبد. وكرئيس للكونغرس التباوي أقول إننا سنقف لها بالمرصاد».
وعن سبب انفراد إيطاليا بمحاولة وضع حل للأزمة الليبية، بعدما كان الملف الليبي كاملاً في يد البعثة الأممية إلى ليبيا، يقول عبد المجيد - الذي سبق له زيارة فرنسا وتشاد والنيجر - شارحاً: «هذا صراع إيطالي مع فرنسا. أنت تعرف أن الأميركيين هم مَن يسيطرون على الوضع، وهم مَن يعطون التعليمات للبعثة الأممية. إنهم يقولون إن الهدف من المؤتمر توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لكنني أرى أنه مجرد محاولة لتثبيت السراج في منصبه. ولهذا إيطاليا كانت دائماً ضد إجراء الانتخابات في ليبيا».
أخيراً، من الأحزاب السياسية يقول عز الدين عقيل، رئيس حزب «الائتلاف الجمهوري الليبي»، إنه لن يشارك في المؤتمر «لأسباب عدة»، منها أنه «مجرد محطة جديدة من محطات مط الأزمة الليبية التي يديرها الغرب ولا يحلها. ولأنه شأن إيطالي، لا علاقة لليبيين به إلا ككومبارس». وينهي كلامه بالقول إنه «من دون تدخل مجلس الأمن لإجبار الميليشيات على توقيع اتفاق سلام يفضي إلى تفكيكها ونزع أسلحتها، فإن كل هذا الذي يجري بباريس وبالرمو وغيرها سيظل مجرد حرث في البحر».
- مخاوف من تعديل «اتفاق الصخيرات»
ظهرت مخاوف من مؤتمر بالرمو بين قادة ليبيين كانوا قد ظهروا على المسرح السياسي بناءً على «اتفاق الصخيرات» الذي جرى توقيعه في المغرب عام 2015. وتوجد رغبة دولية في تحريك المياه في الداخل الليبي، من أجل توحيد السلطة التنفيذية.
ومن بين المقترحات المتداولة، التي تحظى باهتمام لدى البعثة الأممية في ليبيا بقيادة الدكتور غسان سلامة، تشكيل مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين، بدلاً من الوضع الحالي الذي ينص على رئيس وثمانية نواب. ومن شأن توصية بهذا الشأن تصدر عن مؤتمر بالرمو أن تقلب الأوضاع في ليبيا رأساً على عقب، إذ سيبدأ البحث عن الطريقة التي ستُدار بها المؤسسة العسكرية، ودور المشير خليفة حفتر في مثل هذه الترتيبات.
وما يزيد من صعوبة الأمر أن معظم القيادات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي، ومدينة مصراتة ذات التسليح القوي، ضد أي وجود لحفتر في مستقبل ليبيا. وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد زار مدينة مصراتة، بالأمس، كما أنه يحظى بدعم من قيادات محسوبة على تيار الإسلام السياسي. وحالياً، يسعى السراج جهده للبقاء على رأس هرم السلطة في ليبيا من خلال تحالفات شتى، يعمل على عقدها منذ أسابيع.
ومن جهة أخرى، يرى بعض ممن سيشاركون في مؤتمر بالرمو أن تلعب دول مثل روسيا وفرنسا ومصر دوراً للحفاظ على قيادة حفتر للجيش، والدفع في طريق استكمال توحيد المؤسسة العسكرية الليبية برعاية مصرية، وليس أي طرف آخر.